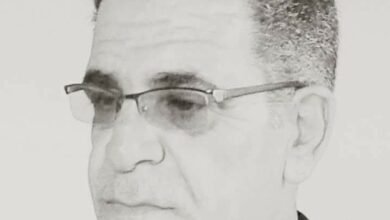أحمد البصيلي يكتب: السنين العجاف بين العمل والأمل

لعلنا نتذاكر دوما قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع ملك مصر، وتأويل رؤياه، كما نتعبّد لله تعالى بتلاوة ما فعله يوسف عليه السلام في تأويله لرؤيا الملك وتطبيقه لهذا التأويل، ونتعلم على المستوى الفردي والمؤسسي من هذه الخطة المُحكمة التي ابتكرها سيدنا يوسف والتي ملخصها: كسب الوقت في سنوات الرخاء، بمضاعفة الإنتاج، وتخزينه بأسلوب علمي؛ للاستفادة منه في سنوات الجدب.
ولعل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر على البشرية بين الفينة والأخرى، جاءت لتذكّرنا بفقه الحاجة وضرورة العمل.. وأن كثيرا من النعم التي اعتدنا على وجودها في حياتنا من الممكن أن تختفي في أي لحظة، مما يستوجب منا أن نتعامل معها بمسؤولية وشكر.
وأن كثيرًا من احتياجاتنا والتي ننفق عليها المليارات من العملة الصعبة.. من الممكن الاستغناء عنها.. وهنا تأتي مقولة: “أفكلما اشتهيت اشتريت؟!” مما يحتم علينا التحلي بفقه الأولويات ومراعاة الأهم فالمهم فالأقل أهمية.. وهكذا.. على المستوى الاقتصادي وغيره من المجالات.
ولولا الأمل ما كان عمل، ولذلك قرن الإسلام بين اليأس والكفر، وبين الإيمان والأمل.. ولا ييأس من رَوح الله إلا القوم الكافرون، وكما يحارب الإسلام كل مظاهر اليأس، فإنه بنفس الدرجة يقاوم الكسل ويعتبره عدوا للدين والدنيا، وكثيرا ما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، بل ويقرنه بالعجز، باعتبار أن نتيجتهما واحدة، فإذا كان العجز عبارة عن عطب وعطل يصيب الجوارح، فإن الكسل هو تعطيل القلب الذي بصلاحه ينصلح سائر الجسد وإذا فسد فقد فسد الجسد كله.
وإذا كان الحل بالنسبة لليأس هو الأمل؛ فإن الحل بالنسبة للكسل هو العمل! والعمل الذي يسهم في انتشالنا من أزماتنا الخانقة لابد أن يكون مجهودا إراديا واعيا يَستهدِف منه الإنسانُ إنتاجَ السلعِ والخدمات لإشباع حاجاته، وعليه فمجهودُ الإنسان بغير هدف لا يعتبر عملا، وتقييم العمل يكون باتساع رقعته، وامتداد أمده، وعمق وسمو تأثيره.
والإسلام يعظم من شأن العمل، فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه, والجزاء من جنس العمل. “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ”، والأنبياء الذين هم أفضل خلق الله – عليهم صلوات الله وسلامه – قد عملوا، فقد عمل آدم بالزراعة، وداود بالحدادة, وعيسى بالصباغة, ومحمد r برعي الغنم والتجارة، فلا يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله, ولو عمل في أقل الأعمال فهو خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يقول عليه الصلاة والسلام: (لأن يأخذ أحدكم حبله, ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب, فيبيع فيأكل ويتصدق, خير له من أن يسأل الناس) ولا يحث الرسول (صلي الله عليه وسلم) علي مجرد العمل ولكن علي إتقانه أيضا فيقول: (إن الله يحب أحدكم إذا عَمِلَ عملاً أن يتقنه، قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال :” يخلصه من الرياء والبدعة). فليست البطولة في أن تعمل ولكنها في إتقان العمل وعمق تأثيره وسموّه. ” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا”.
إذن علينا أن نعتمد على الاستثمار الممنهًج للطاقات والموارد في حدود الممكن والمتاح، وهذا ما فعله القائد الأكبر عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة، حين جاءه r شاب وسأله مالا.. فقال له r: أما في بيتك شيء؟، قال: بلى: حِلْسٌ «الحلس: كساء يوضع على ظهر البعير أو يفرض في البيت تحت حر الثياب» نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَعْبٌ «والقعب: القدح – الاناء» نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما، فاتاه بهما، فأخذهما رسول الله r ، وعقد أول مزاد في تاريخ الإسلام.
وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم، فقال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا: قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاماً وانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به، فشد رسول الله r عودا بيده (وجهّزه ليكون يدا للقادوم) ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما.! فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، حينها قال له سيدنا رسول الله r : “هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة”. وفي هذا الحديث نجد النبي r لم يُرِد للأنصاري أن يأخذ من الزكاة وهو قوي على الكسب، ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك، وأعيته الحيل، وولي الامر لابد أن يعينه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أمامه، وتهيئة الجو العام للاستثمار والكسب.
نعم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون، كما لم يعالجه بالوعظ المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع آخرون، ولكنه أخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجحة، في حدود ما توافر لديه من إمكانات وموارد وملكات.. وهذا ما ينبغي أن يتبناه المجتمع “مواطنون ومسؤولون”.
والإنسان إذا رُزِقَ التوفيقَ في جدْوَلة اهتماماته، وتنظيم عمله، يستطيعُ أنْ يُطيلَ عمرَه إلى ما شاء الله بعد موته ، فيحيا وهو ميت، ويؤدّي رسالتَه وهو تحت التراب ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :”إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ”. فكيف إنْ لم يكن له عملٌ أصلاً، ووافتْه المنيّة؟!ُ .
وفي حديثٍ آخرَ تضمّنَ تفصيلاتٍ لهذه الثلاث، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ”.
ويقول عليه الصلاة والسلام: ” مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ”. فلينظر ابن آدم أي الطريقين يختار!.
يقول ابن عطاء الله السكندري: رُبَّ عُمُرٍ اتَّسعت آمادُه، وقلَّتْ أمدادُه، ورُبَّ عُمُرٍ قليلةٌ آمادُه، كثيرةٌ أمدادُه، ومَنْ بوركَ له في عُمرِه أدركَ في يسيرٍ مِنَ الزمنِ مِنَ المِنَنِ ما لا يدخلُ تحتَ دائرةِ العبارةِ، ولا تلحقُه وَمْضَةُ الإشارةِ.
ومن الملاحظ أن أكثر من مائتي آية، قرن الله فيها العلم بالعمل، لأن العلم بحد ذاته ليس غاية ، إنما هو وسيلة لأداء وظيفة في الحياة، فما لم يُستخدَم العلم من أجل رفع مستوى العمل ، ومن أجل نفع البشر ، فلا قيمة له ، فالناس يحاسبون على أعمالهم، وما العلم إلا من أجل العمل الصالح، فحجم الإنسان عند الله بحجم عمله ، قال تعالى: “وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا”.
وعليه؛ فإننا إذا أردنا التغيير والعزة، فالسبيل هو العمل الجاد الممنهج، المقترن بالأمل الفسيح في الله.. وإذا اقترن العمل بالأمل فثَمَّ التوفيق.. فالله علق خيرية هذه الأمة على شرط الجدية، والإيجابية، والعمل المجتمعي، والتكافل الاجتماعي القائم على التكاتف والتناصح، والتواصل مع الله.. حين قال: “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ..”. ولذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب: “من سرّه أن يكون من هذه الأمة فليؤدِّ شرطَ الله فيها”.
وفي حديث رائع عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ”.
والحق أن الأرض بما فيها، وما عليها ، والسماوات كذلك ، مُسخّرة للإنسان، لكن الخيرات التي أودعها الله في الأرض ، والتي سخرها للإنسان، لا يستطيع أن يستفيد منها الإنسان غالبا إلا إذا تدخل بجهد منه (علما أو عملا)، هذا الجهد الذي يبذله الإنسان، من أجل أن تصبح هذه الخيرات قابلةً للانتفاع بها ، فالبئر لابد من أن تحفر، والنبات لابد من أن يزرع ، والمعادن لابد من أن تستخلص، وفوق ذلك أودع الله في الإنسان دوافع فطرية، خلق له حاجةً إلى الطعام والشراب وأودع فيه الدافع نحو الطعام والشراب، وأودع فيه الحاجة إلى الجنس الآخر، فخلق فيه هذه الغريزة ، وأودع فيه رغبة في التفوق، أو ما يسميه علماء النفس تأكيد الذات.
فالإنسان من جهة يحس بالجوع ، إذاً يبحث عن الطعام ، يحس بحاجة إلى الطرف الآخر، يبحث عن زوجة ، يحس بحاجةٍ إلى تأكيد ذاته، إذاً يتجه نحو البطولة، وبقاء أثره بعد موته.
والحاجة إلى الشئ هي السبب الأعمق في إنتاجه وإيجاده، ولولا الحاجة إليه لكان وجوده عبثاً لامبرر له، والسعي من أجله تضييعاً للجهد والمال والوقت الإنساني الثمين.
وفلسفة المسؤولية في الإسلام مبناها توفير المنهج الواضح الذي يقوم عليه العمل الناصح، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي يصطفُّ حولها جموع الشعب، وبناء على ذلك، فالذي يتولى أمرا من أمور الرعية لابد وأن يكون عنده من الكفاءة “عملا وأملا” ما يؤهله لذلك؛ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعين والياً على بعض الأمصار.
وكان من عادته أن يمتحن ولاة الأمر، سأله هذا السؤال، ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟ فالجواب الذي يعرفه الوالي، قال: أقطع يده، فقال عمر: إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع، أو عاطل، فسأقطع يدك، وتوجه إلى الوالي، قال يا هذا: إن الله قد استخلفنا عن خلقه، لنسد جوعتهم ، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك، تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل ، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً ، فاشغلها بالطاعة، قبل أن تشغلك بالمعصية .
والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى شاباً ما بين الصلاتين ، سأله ماذا تعمل ؟ لا أعمل شيئاً ، سأله النبي الكريم ، من يطعمك ؟ قال أخي ، قال أخوك أعبد منك ، وحينما أمسك بيد عبد الله بن مسعود ، فرآها خشنة ، أمسكها ورفع يد ابن مسعود بين أصحابه وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله .
وإن حرفة الإنسان ، وعمله بهذه الشروط تنقلب إلى عبادة – مع أن ظروف المعيشة توجبها عليه -، بل إن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا مع النبي الكريم وقد مر رجل يحتطب، فرأوه ذا جلد، ونشاط ، فقال بعضهم يا رسول الله : لو كان هذا في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا الرجل يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها ، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً، فهو في سبيل الشيطان .فينبغي أن نتعامل مع مصطلح “في سبيل الله” بهذا الشمول وتلكم الواقعية، فمدلوله يستغرق نشاطات الحياة كلها.
وفي حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله لرجلٍ وهو يعظه: “اغتنِمْ خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِك، وصحتَك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغَك قبل شُغلك، وحياتَك قبل موتك”.